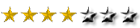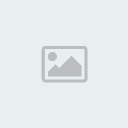تبدأ ب فلسفة قصة
حول الإسراء والمعراج
وكما عرفنا الرافعى وما أُعطِىَ من أدب فى الأسلوب ورفعة فى الأداء وقوة فى الطرح
كلمنا حول الإسراء ولكنه بطبيعته الفلسفية أراد أن يوضح لنا مقدمات توضح لنا
أسباب الرحلتين العظيمين
فبدأنا بقصة جميلة أسماها
فـــــلـــســـــفـــــــــــــــة قـــصـــــــــــــــــــــــة
وحولها بدأ وقال :
ماتت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومات عمه أبو طالب في عام واحد، في السنة العاشرة من النبوة، فعظمت المصيبة فيهما عليه، إذ كان عمه هذا يمنعه من أذى قريش, ويقوم دونه فلا يخلصون إليه بمكروه؛ وكان أبو طالب من قريش كالعقيدة السياسية, هي بطبيعتها قوة نافذة على قوة القبيلة؛ فمن ثم كان هو وحده المشكلة النفسية المعقدة التي تعمل قريش جاهدة في حلها، وقامت المعركة الإسلامية الأولى بين إرادتهم وإرادته، وهم أمة تحكمهم الكلمة الاجتماعية التي تسير عنهم في القبائل؛ وتاريخهم ما يقال في الألسنة من معاني المدح والذم، فيخشون المقالة أكثر مما يخشون الغارة، وقد لا يبالون بالقتلى والجرحى منهم، ولكنهم يبالون بالكلمات المجروحة.
فكان من لطيف صنع الله للإسلام، وعجيب تدبيره في حماية نبيه صلى الله عليه وسلم, وضع هذه القوة النفسية في أول تاريخ النبوة, تشتغل بها سخافات قريش، وتكون عملا لفراغهم الروحي، وتثير فيهم الإشكال السياسي الذي يعطل قانونهم الوحشي إلى أن يتم عمل الأسباب الخفية التي تكسر هذا القانون، فإن المصنع الإلهي لا يخرج أعماله التامة العظيمة إلا من أجزاء دقيقة.
أما خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقوله "نعم" للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس "لا"؛ وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة, وتلد له المسرات من عواطفها كما تلد من أحشائها فالوجود يعمل بها عملين عظيمين: أحدهما زيادة الحياة في الأجسام، والآخر إتمام نقصها في المعاني.
ويموت أبي طالب وخديجة، أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وقلبه، ليتجرد من الحالة التي يغلب فيها الحس، إلى الحالة التي تغلب فيها الإرادة، ثم ليخرج من أيام الاستقرار في أرضه، إلى الأيام المتحركة به في هجرته، ثم لينتهي بذلك إلى غاية قوميته الصغيرة المحدودة، فيتصل من ذلك بأول عالميته الكبرى.
وأراد الله -تعالى- أن يبدأ هذا الجليل العظيم من أسمى خلال الجلال والعظمة، ليكون أول أمره شهادة بكماله، فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة من قومه، فحلمه بشهادة رعونتهم، وأناته بدليل طيشهم، وحكمته ببرهان سفاهتهم؛ وبذلك ظهر الروحاني روحانيا في المادة.
قالوا: فنالت منه قريش، ووصلوا من أذاه إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياة عمه، حتى نثر بعضهم التراب على رأسه، كأنما يعلمونه أنه أهون عليهم من أن يكون حرا، فضلا عن أن يكون عزيزًا، فضلا عن أن يكون نبيا؛ قالوا: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي!
كانت تبكي إذ لا تعلم أن هذا التراب على رأس النبي العظيم هو شذوذ الحياة الأرضية الدنيئة, في مقابلة إنسانها الشاذ المنفرد، هذه القبضة من التراب الأرضي قبضة سفيه، تحاول رد الممالك الإسلامية العظيمة أن تنشأ نشأتها وتعمل عملها في التاريخ، فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتها، كعقل قريش حينئذ في مقداره وسخافته ومحاولته.
أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبنته: "يا بنية لا تبكي، فإن الله مانع أباك". حسبت ذلك هوانا وضيعة، فأعلمها أن قبضة من التراب لا تطمر النجم، وأن هذه الحثوة الترابية لا تسمى معركة أثارتها الخيل فجاءت بنتيجة، وأن ساعة من الحزن في يوم، لا يحكم بها على الزمن كله، وأن هذه النزوة التي تحركت الآن هي حمق الغباوة: قوتها نهايتها.
"يا بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك". أي ليس للنبي كبرياء ينالها الناس أو يغضون عنها فيأتي الدمع مترجما عن المعنى الإنساني الناقص مثبتا أنه ناقص، إنما هي النبوةك قانونها غير ما اعتادت النفس من أفراح وأحزان، وهي النبوة: تجعل المختار لها غير محدود بجسده الضعيف، بل حدوده الحقائق التي فيها قوتها، فهو في منعة الواقع الذي لا بد أن يقع، فلو أمكن أن يحذف يوم من الزمن أو يؤخر عن وقته، أمكن أن يؤخر النبي أو يحذف.
"يا بنية لا تبكي إن الله مانع أباك" لا -والله- ما يقول هذه الكلمة إلا نبي
وسع التاريخ في نفسه الكبيرة قبل أن يوجد هذا التاريخ في الدنيا، فكلمته هي الإيمان والثقة إذ يتكلم عن موجود.
تراب ينثره سفيه على رأس النبي! ويحك يا حقارة المادة؛ إن ارتفاعك لعنة، إن ارتفاعك لعنة.
قالوا: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف، يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادتهم وأشرافهم، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته والقيام معه في الإسلام على من خالفه من قومه، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط1 لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من السفهاء.
فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم في مجلسه قال: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس؛ يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك".
ألا ما أكمل هذه الإنسانية التي تثبت أن قوة الخلق هي درجة أرفع من الخلق نفسه, فهذا فن الصبر لا الصبر فقط، وفن الحلم ولا الحلم وحده.
قوة الخلق هي التي تجعل الرجل العظيم ثابتا في مركز تاريخه لا متقلقلا في تواريخ الناس، محدودا بعظائم شخصيته الخالدة لا بمصالح شخصه الفاني، ناظرا في الحياة إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى الوضع المتغير للمنفعة.
وما كان أولئك الأشراف وسفهاؤهم وعبيدهم إلا معاني الظلم، والشر، والضعف، تقول للنبي العظيم الذي جاء يمحوها ويديل منها: إننا أشياء ثابتة في البشرية.
لم يكن منهم الأشراف والسفهاء والعبيد، بل كان منهم العسف، والرق، والطيش، تسخر ثلاثتها من نبي العدل، والحرية، والعقل، فما تسخر إلا من نفسها.
صغائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياة، لتثبت الصغائر أنها الصغائر، وليثبت المجد أنه المجد.
كان الفريقان هما الفكرتين المتعاديتين أبدا على الأرض: إحداهما عش لتأكل وتستمتع وإن أهلكت، والأخرى عش لتعمل وتنفع الناس وإن هلكت.
كانت الأقدار تبادي هذا الروح الواسع بذلك الروح الضيق، لينطلق الواسع من مكانه ويستقبل الدنيا التي عليه أن ينشئها. فأولئك الأشراف والسفهاء والعبيد إن هم إلا الضيق، والركود، وذل العيش، حول السعة الروحية، والسمو، وطهارة الحياة.
وقف المعنى السماوي بين معاني الأرض، ولكن نور الشمس ينبسط على التراب فلا يعفره التراب، وما هو بنور يضيء أكثر مما هو قوة تعمل بالعناصر التي من طبيعتها أن تحول، في العناصر التي من شأنها أن تتحول.
وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك المستهزئين قوة أخرى, هي القدرة التي تعمل بهذا النبي للعالم كله، وبهذه القدرة لم ينظر النبي إلى قريش وصولتهم عليه إلا كما ينظر إلى شيء انقضى، فكان الوجود الذي يحيط به غير موجود، وكانت حقيقة الزمن الآتي تجعل الزمن الحاضر بلا حقيقة.
وإلى هذه القدرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء البليغ الخالد، يشكو أنه إنسان فيه الضعف وقلة الحيلة، فينطق الإنساني فيه بالشطر الأول من الدعاء يذكر انفراده وآثار انفراده، ويتوجع لما بينه وبين إنسانية قومه، ثم ينطق الروحاني فيه بعد ذلك إلى آخر الدعاء متوجها إلى مصدره الإلهي قائلا أول ما يقول: "إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي".
ولعمري لو نطقت الشمس تدعو الله لما خرجت عن هذا المعنى ولا زادت على قوله: "أعوذ بنور وجهك" تلتمس من مصدر النور الأزلي حياطة وجودها الكامل.
ولق هزئوا من قبل بالمسيح "عليه السلام" فقال للساخرين منه: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. وبهذا رد عليهم رد من انسلخ منهم، وقال لهم قول من ليس له حكم فيهم،
ليست لكل قلب ولا لكل عقل، ولكنها لمن أعد لها؛ وشريعته أكثرها في التعبير وأقلها في العمل، ولم تجئ بالقوة العاملة فلم يكن بد من أن تضع الموعظة في مكان السيف، وأن تكون قائمة على النهي أكثر مما هي قائمة على الأمر، وأن تكون كشمس الشتاء الجميلة: لا تغلي بها الأرض، وإنما عملها أن تمهد هذه الأرض لفصل آخر.
أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يجب المستهزئين, إذ كانت القوة الكامنة في بلاد العرب كلها كامنة فيه، وكان صدره العظيم يحمل للدنيا كلمة جديدة لا تقبل الدنيا أن تعامله عليها إلا بطريقتها الحربية؛ فلم يرد رد الشاعر الذي يريد من الكلمة معناها البليغ، ولكنه سكت سكوت المشترع الذي لا يريد من الكلمة إلا عملها حين يتكلم؛ وكان في سكوته كلام كثير في فلسفة الإرادة والحرية والتطور, وأن لا بد أن يتحول القوم، وأن لا بد أن يتفطر هذا الشجر الأجرد عن ورق جديد أخضر ينمو بالحياة.
لم يتسخط ولم يقل شيئا, وكان كالصانع الذي لا يرد على خطأ الآلة بسخط ولا يأس، بل بإرسال يده في إصلاحها.
قالوا: ورأى ابنا ربيعة، عتبة وشيبة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من السفهاء، فتحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع يده قال: "بسم الله" ثم أكل؛ فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: -والله- إن هذا لكلام ما يقوله أهل هذه البلدة.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟".
قال: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟". قال: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال صلى الله عليه وسلم "ذاك أخي, كان نبيا وأنا نبي".
فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه.
يا عجبا لرموز القدر في هذه القصة!
لقد أسرع الخير والكرامة والإجلال فأقبلت تعتذر عن الشر والسفاهة والطيش، وجاءت القبلات بعد كلمات العداوة.
وكان ابنا ربيعة من ألد أعداء الإسلام، وممن مشوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش يسألونه أن يكفه عنهم أو يخلي بينهم وبينه، أو ينازلوه وإياه حتى يهلك أحد الفريقين, فانقلبت الغريزة الوحشية إلى معناها الإنساني الذي جاء به الدين، لأن المستقبل الديني للفكر لا للغريزة.
وجاءت النصرانية تعانق الإسلام وتعزه، إذ الدين الصحيح من الدين الصحيح، كالأخ من أخيه، غير أن نسب الإخوة الدم ونسب الأديان العقل.
ثم أتم القدر رمزه في هذه القصة، بقطف العنب سائغا عذبا مملوءًا حلاوة؛ فباسم الله كان قطف العنب رمزًا لهذا العنقود الإسلامي العظيم الذي امتلأ حبا كل حبة فيه مملكة.
حقا إنها لمقدمة عظيمة حول رحلة جليلة سردها عالم حقا
_________________
<br>